لليبرالية (إجمالاً)
فلسفة سياسية تؤمن بالانطلاق بحريات وحقوق الفرد إلى أقصى حد. ويؤمن الليبرالي،
ضمن ما يؤمن، أن دور الدولة الأول هو حماية حقوق مواطنيها[1].
والعلمانية هي التفكير في النسبي بما هو نسبي وليس بما هو مطلق؛ فالسياسة، كما
عبَّرَ مكيافلي، "لا تستند إلى قيم دينية أو قيم أخلاقية مطلقة،
وإنما إلى المصلحة والمنفعة"[2].
ومن هنا كان رفضي لإقحام
الدين أصلاً في السياسة والتشريعات المدنية والقوانين والدساتير! "ليس من حق أحد أن يقتحم،
باسم الدين، الحقوق المدنية والأمور الدنيوية (جون لوك في 1689م!)[3]. فنحن في مجتمع تتباين
أطيافه الدينية (ما بين إسلام ومسيحية والمنبثقين من كلٍ، وأقليات يهودية وبهائية
إلخ)، وفي رأيي نحن أمام الاختيارات التالية:
1. منح كل فئة الحق الكامل
في تطبيق شرائعها وخصوصياتها (حل هزلي ينتهي بالوطن إلى التفتت وبالمواطنين إلى
الاقتتال).
2. تقديم شرائع دين
"الأغلبية" مع منح الاستثناءات "للأقليات" فيما يخصهم
3. العلمانية، أي فصل الدين
عن خصوصيات تشريع وتقنين الدولة، فيقف الجميع متساويين.
وفي تفنيد الافتراضين (1)
و (2)، اقرأ معي الرأي الآتي:
"فإذا امتلك كل نسق اجتماعي
حقيقة واحدة، وتصورها على أنها مطلق يصبح لدينا أكثر من مطلق. وهذه نتيجة مناقضة
لطبيعة المطلق، الذي هو بحكم طبيعته واحد لا يتعدد وهذا هو السبب الذي من أجله لا
يكون في الإمكان حدوث التعايش السلمي بين المطلقات لأنها في هذه الحالة تفقد
مطلقيتها. ويمكن القول بأن المطلقات، في حالة تعددها، تدخل في صراع من أجل الوجود
والبقاء للأصلح في نهاية المطاف.
بيد أن هذا الصراع يمارسه
النسبي أي الإنسان باسم المطلق. ولهذا فإذا اعتنق إنسان مطلقاً ما فإنه يناضل من
أجله إلى الحد الذي يشعل من أجله حرباً ضد مَنْ يعتنق مطلقاً آخر. وهذا ما اسميه
(جريمة قتل لاهوتية)."[4]
وأنا شخصياً أرى أن قبول إقحام تشريعات دينية بعينها على مجتمع (متعدد الأطياف الدينية) في خصوصياته المدنية تحت مسمى أنها "حق إلهي"، هو بداية فتح الباب أمام انتهاك الحقوق والحريات! فاليوم ننظم الأحوال الشخصية، مثلاً، بالحق الإلهي، وغداً نُحَرِّم ونُكَفِّر الإبداع لأنه اختلف مع الحق الإلهي، وبعد غد نقطع الرقاب لأنها حملت رؤوس مَنْ خالفوا آراء ممثلي الحق الإلهي.
كما أن تقنين الاستثناءات
واحتكام كل فئة دينية لشرع خاص بها سيكون ميلاد غول طائفية جديد (مثلاً تغيير
الدين سعياً وراء حكم ديني يُرى فيه مصلحة أو يسر أو إلخ) في مجتمع مشحون مسبقاً
وطائفي بطبعه – ولا تقل لي "تسامح"، فالتسامح لا يكون هبة من السلطة
القائمة، إذ أن – في هذه الحالة – هذه السلطة عبارة عن طغيان الأغلبية على
الأقليات، "وتكون إيديوليوجيا التسامح في الحقيقة إيديولوجيا تحافظ على
الوضع القائم المستند إلى الظلم والتفرقة" (هيربرت ماركوزه)[5].
لذلك – وعودة إلى يابسة الواقع من بعد سحب الفلسفة – كان قبول التشريعات "الوضعية" المستمدة من خبرات دول مدنية ديمقراطيتها صحيحة. فهذه القوانين نسبية، ولا تنفي عن نفسها نسبيتها بل تنظم آليات تغييرها حين يتطلب الأمر! فإن اعترض معترض، مثلاً، على ما يراه قسوة في قطع يد السارق (حد إسلامي) أو رجم مَنْ سجد لغير الله (تشريع توراتي)، سيجرفه سيل هادر من أصوات تصرخ "هذا شرع الله!" – وبهذا تُسَد كل سبل النقاش. أما حين يعترض المعترض على حبس السارق عدد ص من السنوات، يدور نقاش: هل نشدد العقوبة؟ هل نخففها؟ هل نأخذ في الاعتبار عمر أو جنس السارق؟ أو حالته المادية أو الصحية؟ هل نفكر في حياته بعد عقابه وإصلاحه؟ هل للمجتمع أن يستفيد منه حتى وهو في محبسه؟ وهكذا.
وإذا جادل احد
"اولياء الدين والدنيا" قائلاً: حسن، إذاً لنضع الشريعة
الإسلامية في قالب دستور وقوانين مدنية لتقبلوه. سيكون ردي: بشرط أن تُعامَل حينذاك معاملة
القوانين المدنية، من حيث التسليم بنسبيتها وإمكانية تطويرها أو تبديلها أو
مناقشتها أو الاستغناء عنها إن لزم الأمر، مع وجود آليات للطعن أو النقض أو
الاستئناف إلخ – أم أنني سأجد من يرفع في وجهي، من جديد، "هذا شرع
الله"؟
الحل إذاً في رأيي هو العلمانية. وتشريعات الأديان، أنتجاهلها؟ لا! واسوق هنا مثالاً واقعياً بسيطاً، قضية تثير قلاقل الى يومنا هذا في مصر، شاحنةً الاجواء بين الدولة والكنيسة، قضية الزواج والطلاق لدى المسيحيين. ففي دول الغرب التي تسمح بالطلاق، يسجل الزوجان المسيحيان زواجهما مدنياً، وإذا كانوا راغبين في إعمال عقيدتهم ودينهم، يسجلون زواجهم كنسياً أيضاً، معلنين التزامهم بتعاليم دينهم في هذا الشأن. وانتهت المسألة!
اختم أخيراً بما قاله الفيلسوف
الانجليزي جون لوك:
"لأن خلاص النفوس من شأن الله وحده. ثم إن الله لم يفوض أحداً
في أن يفرض على أي إنسان ديناً معيناً. ثم إن قوة الدين الحق كامنة في اقتناع
العقل، أي كامنة في باطن الإنسان".[6]
المراجع
[1] Britannica Concise Encyclopedia
[2] مراد كامل وهبة، مٌلاك الحقيقة المطلقة – ما العلمانية؟ مكتبة الأسرة 1999
[3] Locke, A Letter Considering Toleration, The Liberal Arts Press, New York, 1960, pp.17-18
[4] مراد كامل وهبة، مُلاك الحقيقة المطلقة – مُثُل التنوير في هذا الزمان، مكتبة الأسرة 1999
[5] R. P. Wolff, Barrington Moore, Herbert Marcuse, A Critique of Pure Tolerance, Beacon Press, Boston, 1965

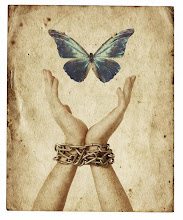
0 comments:
Post a Comment